شيماء طنطاوي تكتب: شيماء بنت «إكرام» .. عن أمي أكتب
شيماء طنطاوي
منسقة برنامج المبادرات النسوية بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية،خريجة المدرسة السنوية فى دورتها عام 2013، شاركت فى عدد من العروض لمشروع بصي أبرزها “عاش يا وحش”، وأخيرًا شاركت فى إعداد دليل المبادرات النسائية/ النسوية الصادر عن مؤسسة نظرة.
لم أكتب يومًا عن أمي، ربما لأنني مازلت أحتفظ بجزء من الأبوية التي تربيت عليها منذ نعومة أظفاري، أو قد يكون لقلة المواقف التي تجمعني بها بشكل صريح، أو لحبي الدفين لها، وشبهي الكبير بها، الذين لم أتعرف عليهما مسبقًا.
في أحيان كثيرة، كنت أشعر أننا بيننا شكل من أشكال التواصل غير المرئي، حينما أكون مريضة بدون أسباب واضحة، أعلم أن أمي قد تشعر بنفس الاَلم.
اليوم أكتب عن أمي والتضامن النسوي الفطري، وأكتب فقط عن موقفين من أهم المواقف في حياتي، ولكن قبل ذلك دعوني أعرفكم بها، أمي “ست بيت” كما يقولون فهي سيدة من قرية بإحدى محافظات الصعيد، غير متعلمة، ولكنها تجيد الرياضيات بشكل ملفت ومبهر، مثقفه جدًا، متابعة جيدة للأخبار، ولها رأي ودائمًا لها وجهة نظر في الأمور المختلفة، طيبة إلى أبعد مدى، لم أكن أعتقد أنها بهذه القوة لولا الموقف الأخير الذي مررنا به سويًا.
كانت تحلم دائمًا منذ صغرها أن تصبح “دكتورة”، قالت لي مرارًا “لولا أن أبويا مرضيش يخليني أكمل تعليمي كنت هابقى دكتورة في الجامعة أنا مخي نضيف”، تتذكر أمي موقفًا أليمًا يخص مسألة تعليمها، وتحكي لي أنها خرجت ذات مرة لتحضر أحد الدروس التعليمية في القرية، وإذا بجدتي تنادي عليها من البيت وعلى الرغم من أن المسافة بين البيت وهذا المكان بعيدة، إلا أن أمي سمعت نداءها، فعادت إلى البيت مسرعةً ولم تذهب هناك مرة أخرى.
كانت السياسة المتبعة في العائلة قديمًا، هي تعليم الذكور وواحدة فقط من الفتيات، وعلى الرغم من “عشق” أمي للتعليم، لكن جدي لم يخترها لتكمل تعليمها واختار إحدى أخواتها.
الموقفان اللذان تضامنت فيهما أمي معي تضامنًا نسويًا أصيلاً وفطريًا هما:
الأول، حينما رسبت في السنة الأولى بالجامعة، ووقعت مشادة كلامية بيني وبين والدي الحبيب – الأقرب دومًا إلى قلبي والداعم لي على طول الخط – ومع إتهام والدي لي بالتقصير وقتها، إنهارت أعصابي ودخلت في وصلة بكاء، وصرت أصرخ بصوت عالٍ دفاعًا عن نفسي، أؤكد أنني بذلت مجهودًا كبيرًا هو لا يعرفه حتى أنجح، فتصاعدت المشادة وأوشك أبي أن يصفعني على وجههي لأول مرة في حياتي، ما دفع أمي أن تقف جاجزًا بيني وبينه لتحول دون ضربه لي، فلو كان صفعني أبي على وجهي، لأنكسر كل شيء بي وكل شيء تجاهه داخلي، ودافعت عني يومها باستماتة، لم أكن لعتقد أنها تحبني هكذا، لم أكن أتوقع أنها ستدافع عنيبهذا الشكل.
أما الموقف الثاني، وهو ما دفعني أن أكتب عنها، إنني منذ بدأت في رحلة دراستي وعملي، التي اخترتها بإرادتي الحرة، وأمي تأخذ موقف المشاهدة ولا تتدخل إلا بكلام بسيط “أنا مش عايزاكي تقعدي في البيت تخدمي أخواتك وزوجاتهم، عايزاكي تتعلمي وتشتغلي وتبقي حاجه كبيرة، بس نفسي برضه أفرح بيكي مش عايزاكي تنسي نفسك وتبقي لوحدك في الاَخر“، حتى أتى اليوم الذي تأخذ فيه موقف المدافعة والمناصرة، وحينما تعمق الخلاف والأزمة وجاء عمي طالبًا أن يأخذني إلى بيته “لـيربيني من جديد ويحكم عليا طالما محدش من أخواتي الولاد قادر يحكمني، ويكسر رقبتي لو لزم الأمر، ومادام الذوق مش نافع معايا يبقى يوريني العافية” ويوجه سهامه تجاه هذه السيدة التي توفى زوجها شابًا، ومع ذلك بقيت شامخة تُدير منزل فيه خمسة رجال وفتاتين، ويتهمها بأنها ليست جديرة بتربيتنا، وليست على مستوى المسؤولية، يتهمها ويعنفها ويرفع صوته أمامها وأمام أخوتي وفي منزلنا، فإذا بأمي ترد بكل هدوء وثقة “بنتي مبتعملش حاجه غلط بتشوف مستقبلها وبتدرس وبتشتغل“.
كنت أتوقع أن تنهار أمي وتبكي غياب أبي ومافعله فيها الزمن، الذي وضعها في هذا الموقف بعد وفاة زوجها، لتصبح هي وبيتها وأسرتها عرضة للإهانات والتعنيف وكسر كل القيم الأخلاقية وحتى المجتمعية.
كنت أعتقد منذ بداية حربي مع عائلتي أنني الحلقة الأضعف ولا يوجد من يقف “في ضهري” ويحميني، ولكن بعد هذا الموقف صرت أعرف جيدًا أن أمي تقف قوية “في ضهري”، أشعر بأمان وجودها، أشعر بتضامنها ومشاعرها التي لم تعلنها لي يومًا بوضوح.
سأصبح يوماً ما يا أمي مثلما تمنيتِ “دكتورة في الجامعة“.
أعلم أن ما كتبت هو تفريغ لمشاعري بشكل كبير، ولكن أردت أن أقول في النهاية أنني أقضي حياتي أتعلم دروس التضامن من نساء كثيرة ولكني دائمًا أتوقع منهن هذا التضامن بحكم وعيهن، أما أمي فهي تعلمني الدرس الأقوى والأجمل والأصدق، إنه درس التضامن الذي لم أكن أتوقعه، والمختلف تمامًا عن كل أشكال التضامن الأخرى.
شيماء بنت إكرام


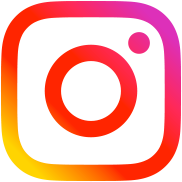






 by
by